النموذج الليبي في إدارة الهامش الاستراتيجي في السياسة الأميركية
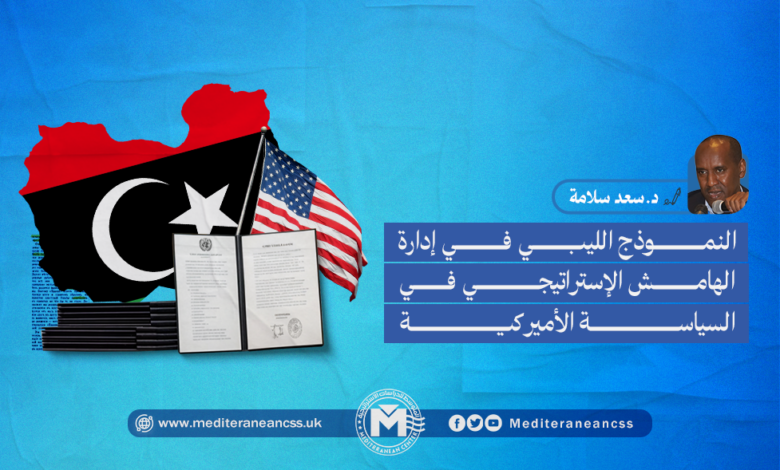
د. سعد سلامة
المدير التنفيذي لمجموعة منحى الأزمة الليبية
ملخص:
تتناول هذه الدراسة موقع ليبيا في الاستراتيجية الأمريكية من خلال مفهوم ” إدارة الهامش الاستراتيجي”، وتنطلق من فرضية مركزية مفادها أن السياسة الأمريكية تجاه ليبيا، لم تشهد تحول نوعي أو قطيعة مع المسار التاريخي، بل جسدت نموذج مستقر يقوم على إدارة الأزمة بأقل كلفة ممكنة بدل السعي إلى حلها أو الانخراط في إعادة بناء الدولة. فرغم ما تمتلكه ليبيا من موارد طاقوية وموقع جيوستراتيجي مهم، ظلت في التصور الأميركي دولة ذات أولوية ثانوية مقارنة بملفات إقليمية أكثر مركزية للأمن القومي الأمريكي.
توصلت الدراسة، إلى أن التدخلات الأميركية في ليبيا كانت ظرفية ومحدودة، ومرتبطة بمواجهة تهديدات محددة دون التزام طويل الأمد بإعادة بناء الدولة. كما تؤكد أن سياسات “أوباما وترامب وبايدن”، رغم اختلاف الخطاب، اتسمت بقدر كبير من الاستمرارية. وتخلص الدراسة إلى أن الولاية الثانية لدونالد ترامب لم تمثل تحولا نوعيا، بل عززت التركيز على حماية المصالح الاقتصادية، مع استمرار غياب الضغوط الجدية لفرض تسوية سياسية. وبذلك تؤكد الورقة أن السياسة الأميركية تجاه ليبيا تعكس خيارا استراتيجيا واعيا يقوم على إدارة الأزمة بأقل كلفة ممكنة، لا على الانخراط الاستراتيجي الشامل.
الكلمات المفتاحية:
ليبيا، السياسة الأمريكية، الهامش الاستراتيجي، الأمن القومي الأمريكي، المصالح الاقتصادية.
مقدمة:
على الرغم مما تتمتع به الأراضي الليبية من موارد طاقة وفيرة وموقع جيوستراتيجي مهم عند مفترق الطرق بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، تظل ليبيا في التصنيف الاستراتيجي الأميركي التقليدي، دولة ذات أولوية ثانوية. فهي لا ترقى إلى مستوى المناطق الاستراتيجية الحيوية والمصيرية في الشرق الأوسط، كدول مجلس التعاون الخليجي ذات الاحتياطيات النفطية الهائلة والتحالفات العسكرية الموروثة، أو “كإسرائيل” ذات العلاقة الاستثنائية[1].
من هذا المنطلق الجوهري، تطرح الورقة فرضيتها المركزية بأن سياسة إدارة ترامب تجاه الملف الليبي لم تكن استثناءً عن القاعدة، ولا تحولاً جذرياً في السلوك والمنطلقات، بل كانت التعبير الأمثل والأوضح عن استراتيجية أميركية تاريخية متجذرة تجاه ليبيا. تقوم هذه الاستراتيجية على منطلق “إدارة الأزمة بأقل تكلفة ممكنة”، بدلاً من السعي الجاد والحاسم لحلها وفق رؤية واضحة ومستقرة. وقد تجلّى هذا النهج بوضوح من خلال تبني واشنطن لنموذج عملي يمكن تسميته “الوساطة المفوضة” أو “الوكالة عن بعد”. حيث سمحت الإدارة الأميركية، بل وشجعت، القوى الإقليمية الفاعلة (مثل تركيا وقطر من جهة، ومصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية من جهة أخرى) وللقوى الدولية المنافسة (لا سيما روسيا الاتحادية، وبدرجة أقل فرنسا) بالإنخراط المباشر والعنيف في الصراع الليبي، وتقديم الدعم العسكري والسياسي واللوجستي للأطراف المتقاتلة، بينما حافظت واشنطن على دور المتحكم في الخيوط الرئيسية من بعيد، والقادر على ممارسة الضغط السياسي وحتى الاقتصادي وحتى التلويح باستخدام القوة، دون أن تتعرض لأعباء الوجود الميداني المكلف أو المسؤولية السياسية المباشرة عن تطورات المشهد الليبي[2].
أولاً- السياق التاريخي لتطور النظرة الأميركية لليبيا
لفهم تعقيدات السياسة الأميركية الراهنة تجاه ليبيا، يقتضي تتبع المسار التاريخي الذي تشكلت من خلاله الرؤية الاستراتيجية لواشنطن، إذ تأثرت هذه الرؤية بتحولات النظام الدولي، وتغير أولويات الولايات المتحدة، وتبدل مقارباتها الأمنية والسياسية تجاه منطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط[3]. فمن الصعب الإحاطة بالموقع الذي احتلّته ليبيا في الوعي الاستراتيجي الأميركي دون العودة إلى الجذور التاريخية التي حكمت علاقة الطرفين منذ منتصف القرن العشرين. إذ أن نظرة السياسة الأميركية كما هي الآن، أو بمعنى أدق الاستراتيجية الأميركية الحالية تجاه ليبيا قد تفهم بشكل أكثر علمية إذا ما وضعت تلك السياسة أو الاستراتيجية ضمن سياق تاريخي تكون نقطة البداية فيه مع انطلاق الحرب الباردة في عام 1947، حين كانت الولايات المتحدة تعمل على تعزيز شبكة من التحالفات والمواقع المتقدمة الممتدة عبر البحر المتوسط بهدف احتواء النفوذ السوفياتي[4].
في هذا الإطار، مثّلت ليبيا، تحت حكم الملك إدريس السنوسي، نقطة ارتكاز مهمّة، سواء بسبب موقعها الجغرافي المطل على جنوب أوروبا، أو لكونها بلداً واعداً في مجال الطاقة، أو لاحتضانها واحدة من أكبر القواعد الأميركية خارج الأراضي الأميركية، وهي قاعدة “هويلس” الجوية قاعدة معيتيقة حاليا في العاصمة طرابلس.
وقد نظر صانع القرار الأميركي آنذاك إلى ليبيا باعتبارها دولة صديقة ومستقرة نسبياً، ذات نظام محافظ يميل إلى الغرب ويقدّم للولايات المتحدة تسهيلات استراتيجية ثمينة. ولعل ما يثبت ذلك، المعلومات التي ضمنها مصطفى بن حليم رئيس وزراء ليبيا في العهد الملكي في كتاب مذكراته والذي وأشار فيه بوضوح إلى أن الموقع الجغرافي لليبيا شكل عامل جذب طبيعي للاهتمام الأميركي والغربي عموماً خلال الحرب الباردة، حيث كانت ليبيا ـ كما يذكر في كتابه – تُمثّل منصة استراتيجية للمراقبة والتحرك عبر البحر المتوسط، وهو ما جعلها ذات قيمة خاصة بالنسبة للولايات المتحدة التي كانت تسعى لاحتواء النفوذ السوفيتي في المنطقة. وبالفعل، لم يكن هذا الاهتمام الأميركي بليبيا مقتصراً على الجغرافيا فحسب، بل شمل أيضاً المصالح الاقتصادية، وخصوصاً بعد تأكيد الإمكانات النفطية الهائلة للبلاد في مطلع خمسينيات القرن الماضي.
وللتدليل على ذلك يشير بن حليم في مذكراته، إلى قاعدة “هويلس” الجوية باعتبارها واحدة من أكبر القواعد الأميركية خارج الولايات المتحدة في تلك الفترة، بأنها مثلت جسراً للتعاون الأمني والعسكري بين الطرفين، ويؤكد على أن صانع القرار الأميركي كان يعتبر ليبيا تحت حكم الملك إدريس السنوسي ـدولة مستقرة نسبياً ومؤهلة للتعاون طويل الأمد مع الغرب، وذلك بفضل طبيعة حكمها المحافظ واستعدادها لتقديم تسهيلات استراتيجية، خاصة في مجالات التمويل العسكري وبناء البنى التحتية الحيوية التي دعمتها واشنطن عبر برامج مساعدات متنوعة[5].
إلا أن العلاقات الأميركية الليبية شهدت تحولاً جذرياً بعد انقلاب العقيد معمر القذافي في الأول من سبتمبر 1969، وذلك بعد أن أوقف نظام حكم القذافي تجديد الاتفاقية العسكرية مع الولايات المتحدة (1970) المتمثلة في استئجار قاعدة “هويلس” الجوية، مما أنهى الوجود العسكري الأميركي المباشر الذي بدأ عام 1954. واقع جديد أصبح مختلفاً أكثر عن سابقيه بتبنى القذافي خطاً أيديولوجياً صريحاً مناهضاً للغرب والاستعمار، ورفع فيه شعارات للوحدة العربية، وقام خلاله بتقديم الدعم لحركات وتنظيمات مصنفة في الغرب كحركات وتنظيمات إرهابية، مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي ومنظمة “أبو نضال” الفلسطينية.
رداً على ذلك، صنفت الإدارات الأميركية المتعاقبة، ليبيا كـ “دولة مارقة” و”راعية للإرهاب”، وخاصة في عهد الرئيس رونالد ريغان، عندما تصاعد التوتر بين الدولتين في شكل مواجهات عسكرية مباشرة، أبرزها حادثة “خليج سرت” الأولى (1981) حيث أسقطت مقاتلات أميركية مقاتلتين ليبيتين، والثانية (1986) التي شنت فيها الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع في طرابلس وبنغازي رداً على اتهامها لليبيا بتفجير “ملهى لا بيل” في برلين الغربية، وفي شكل عقوبات اقتصادية، عندما فرضت الولايات المتحدة حظر على استيراد النفط الليبي (1982) وعندما قامت بتجميد الأصول الليبية (1986)[6].
إلا أنه، ومع هذا التصعيد، بقيت الرؤية الاستراتيجية الأميركية تُصنف ليبيا كتهديد ثانوي يمكن احتواؤه، فليبيا لم تكن تمتلك القوة العسكرية التقليدية أو الوزن الجيوستراتيجي الذي يشكل تهديداً وجودياً للمصالح الأميركية الحيوية.
لذلك ركزت السياسة الأميركية على عزل النظام عبر أدوات الضغط الاقتصادي والدبلوماسي والمخابراتي، مع تجنب التورط العسكري المباشر الواسع، وهو ما انعكس في الأدبيات الأكاديمية والسياسية التي وصفت ليبيا بدولة “مارقة” ذات تأثير محدود في المعادلة الإقليمية الرئيسية حيث صُنِّفت ضمن فئة “التهديدات الثانوية” التي يمكن احتواؤها بأدوات ضغط محدودة دون اللجوء إلى تدخل عسكري واسع أو استنزاف استراتيجي كبير.
ويرتبط هذا التوصيف بعدة عوامل، من بينها:
(1)- لم تكن ليبيا تملك قدرات عسكرية تقليدية تشكّل خطراً مباشراً على المصالح الحيوية للولايات المتحدة أو على موازين القوى الكبرى في البحر المتوسط أو الشرق الأوسط. ورغم أن ليبيا القذافي آنذاك رفعت سقف خطابها السياسي ووسّعت من نشاطها الخارجي، فإنّ بنيتها العسكرية كانت محدودة التأثير . ولذلك رأت واشنطن أنّ أنشطة ليبيا، رغم إزعاجها النسبي، تبقى قابلة للاحتواء من خلال الإدارة الحذرة للصراع بدلاً من المواجهة المباشرة.
(2)- رغم تموضع ليبيا الجغرافي في حوض المتوسط، فإن وزنها الجيوسياسي لم يكن مؤهلاً لإحداث اختلالات جوهرية في التوازنات الإستراتيجية بين الشرق والغرب خلال الحرب الباردة. فقد افتقرت ليبيا إلى شبكة تحالفات دولية مؤثرة، ولم تكن قادرة على استثمار موقعها الجغرافي أو مواردها النفطية لفرض دور إقليمي نوعي يرغم الولايات المتحدة على التعامل معها كقوة مكافئة.
وبناءً عليه، ظلت الاستراتيجية الأميركية تجاه ليبيا محكوماً بفكرة أنّ ليبيا دولة “مارقة” أكثر منها دولة “مهدِّدة”، وهو تمايز بالغ الأهمية في التفكير الاستراتيجي الأميركي[7].
ثانيًا-التحولات الاستراتيجية في السياسة الأميركية تجاه ليبيا
تتبع السياق التاريخي للاستراتيجية الأميركية حيال ليبيا يظهر بوضوح أن انتهاء الحرب الباردة في مطلع تسعينيات القرن الماضي، كان قد شكل لحظة مفصلية هامة في هذا السياق التاريخي.
فليبيا القذافي التي بنت جانباً كبيراً من سياساتها الخارجية خلال السبعينيات والثمانينيات على منطق الصراع مع الغرب، واستثمار التناقضات بين المعسكرين الشرقي والغربي فقدت مع انهيار الاتحاد السوفيتي أحد أهم مكونات البيئة الدولية التي كانت تمنحها هامشاً للمناورة، وتزامن ذلك مع صعود خطاب العولمة الاقتصادية، وتزايد الاعتماد المتبادل بين الدول، واتساع نفوذ المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، إضافة إلى ذلك، شهد النظام الدولي في مطلع تسعينيات القرن الماضي توسعاً في استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة ضغط، الأمر.
كما لا يمكن إغفال التحول في أولويات الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة، حيث انتقل التركيز من احتواء الخصوم الأيديولوجيين إلى إدارة أزمات إقليمية محددة، ومكافحة ما اعتُبر تهديدات جديدة مثل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. هذا السياق الجديد وضع ليبيا أمام معادلة صعبة، الأمر الذي دفعها تدريجياً إلى إعادة تقييم خياراتها الاستراتيجية في ضوء نظام دولي جديد يتسم بالأحادية القطبية وهيمنة الولايات المتحدة.
فقد بدأت ليبيا منذ منتصف التسعينيات في إرسال إشارات تدريجية تفيد برغبتها في تخفيف حدة التوتر مع الغرب. تجلت هذه الجهود في القبول بتسوية قضية لوكربي، والتعاون المحدود مع بعض الدول الأوروبية، ولا سيما بريطانيا وإيطاليا، إضافة إلى تعديل الخطاب السياسي الرسمي، الذي أصبح أقل حدة تجاه الولايات المتحدة والغرب مقارنة بمرحلة الثمانينيات[8].
وانطلاقاً من كون أن قضية اتهامها بمسؤولية الوقوف وراء اسقاط طائرة ركاب مدنية أميركية فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية ورفضها القبول بهذه المسؤولية وما ترتب على هذا الرفض من تداعيات سياسية واقتصادية على الدولة الليبية، كان هو العائق الأبرز والأهم وأمام البدء في أي تسوية سلمية لعلاقاتها المتوترة مع الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية، فإن تراجعها عن حالة الرفض هذه وإعلانها في عام 2003، عن قبولها بالمسؤولية المدنية عن أفعال موظفيها، وموافقتها على دفع تعويضات مالية كبيرة جداً لضحايا الحادث، يعد نقطة التحول الأبرز في مسار العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية وليبيا[9] .
حيث فتحت هذه الخطوة الباب أمام الرفع التدريجي المشروط للعقوبات الغربية المفروضة عليها، قامت بتعزيزها بخطوات ملموسة أخرى في ملفات مكافحة الإرهاب والتخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل. وجاء الإعلان الليبي في ديسمبر 2003 عن التخلي الطوعي عن برامج الأسلحة غير التقليدية ليشكل نقطة مفصلية في هذا المسار.
وكان من نتيجة كل تلك الخطوات أن تم استئناف الاتصالات الدبلوماسية الغربية مع ليبيا، ورفع عنها بعض القيود الاقتصادية، وسمح بعودة الشركات النفطية الأميركية إلى ليبيا، في إطار سياسة أميركية تركز على إدارة المخاطر أكثر من بناء شراكة استراتيجية كاملة.
والملاحظ أنه وحتى بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية رسمياً عام 2004، إلا أن العلاقة الليبية ـ الأميركية ظلت محكومة بسقف منخفض من التفاعل، انحصر فيها الاهتمام الأميركي في قضايا محددة، أبرزها التعاون الأمني، ومكافحة الإرهاب، وضمان عدم عودة ليبيا إلى مسارات تهدد الأمن الدولي.
ولم تتطور العلاقة إلى شراكة سياسية أو اقتصادية واسعة، كما لم تُدمج ليبيا ضمن الرؤى الأميركية الكبرى لإعادة تشكيل المنطقة، وبشكل يمكن القول معه إن هذا السقف المنخفض يعكس استمرار نظرة الحذر وعدم الثقة، إضافة إلى إدراك الولايات المتحدة لمحدودية الوزن الاستراتيجي لليبيا مقارنة بملفات إقليمية أخرى فاعلة كانت نشطة جداً في تلك الفترة هي الحرب في أفغانستان في 2001 والحرب في العراق في 2003.
وهكذا، ظلت ليبيا، رغم عودتها الجزئية إلى ما يسمى بالمجتمع الدولي بعد التحسن النسبي الكبير في علاقاتها مع الولايات المتحدة والدول الغربية، خارج دائرة الأولويات الكبرى في السياسة الخارجية الأميركية طوال الفترة الزمنية من صعود القذافي لحكم ليبيا وحتى سقوط حكمه في منتصف فبراير 2011[10].
لقد أظهر هذا المسار التاريخي أنّ ليبيا، على الرغم من موقعها الحيوي ومواردها النفطية المهمة، لم تنجح في التحوّل إلى شريك استراتيجي حقيقي للولايات المتحدة، ولم تحظَ بالوزن نفسه الذي مُنح لدول أخرى في المنطقة. بل أنها كثيراً ما تعاملت معها بحسب مقتضيات اللحظة الدولية، وبما يخدم اعتبارات أمن الطاقة أو ترتيبات المتوسط أو مكافحة الإرهاب، من دون أن يُترجم ذلك إلى اهتمام مؤسسي ثابت أو إلى سياسة طويلة المدى.
هذا البعد الاستراتيجي في السياسة الأميركية حيال ليبيا الذي تضمنه هذا السياق التاريخي، أصبح أكثر انكشافاً بعد التغير الجذري الكبير الذي تعرضت له منظومة الحكم في ليبيا في فبراير 2011. فعلى الرغم من الدور العسكري الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في إطار تدخل حلف شمال الأطلسي خلال الفترة الممتدة من مارس إلى أكتوبر 2011 لحماية المدنيين، فإن هذا الحضور لم يكن إيذاناً بمرحلة جديدة من الانخراط الاستراتيجي، بل مجرد استجابة ظرفية لحدث استثنائي فرضته تطورات ميدانية متسارعة. وما إن أُسقط النظام رسمياً في أكتوبر 2011، حتى انسحبت واشنطن بسرعة ملحوظة، تاركة الساحة رهناً لتفاعلات داخلية معقدة وصراعات إقليمية متشابكة[11].
وقد عكس هذا الانسحاب استمرار النظرة الأميركية التقليدية إلى ليبيا كملف ثانوي يمكن التعامل معه بأسلوب إدارة الأزمات لا بناء الدول، بل إن كل السنوات اللاحقة أكدت أن هذا التوجّه ظل إطاراً عاماً يحكم تعامل الولايات المتحدة مع التطورات الليبية، حيث اتسمت الاستراتيجية الأميركية تجاه ليبيا بقدر عالٍ من الاستمرارية، على الرغم من تعاقب الإدارات واختلاف السياقات الدولية.
ثالثًا- تحولات السياسة الأميركية في عهدي أوباما وبايدن
في عهد الرئيس باراك أوباما (2009–2017)، بدت الولايات المتحدة شديدة الحرص على تأكيد أن تدخلها في ليبيا لا يتجاوز كونه جزءاً من التزامها الجماعي ضمن حلف شمال الأطلسي، وأنها لا تعتزم تحمل أعباء إدارة المرحلة الانتقالية التي بدأت عملياً مع تشكيل المجلس الوطني الانتقالي في مارس 2011. وقد انسجم ذلك مع فلسفة أوباما العامة في السياسة الخارجية، القائمة على تقليص الإنخراط العسكري المباشر، وتفويض الحلفاء الإقليميين والدوليين بأدوار أكبر، وهو ما ظهر بوضوح منذ عام 2012 في تركها إدارة الملف الليبي السياسي والأمني للأمم المتحدة والدول الأوروبية.
هذا الحضور المحدود لم يكن ناتجاً عن غياب القدرة، بل عن غياب الإرادة السياسية، إذ لم تُدرج ليبيا ضمن قائمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للإدارة الأميركية، التي كانت منشغلة بملفات أكثر إلحاحاً مثل استكمال الانسحاب من العراق عام 2011، وإعادة التموضع في أفغانستان خلال الأعوام 2012–2014، والتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، إلى جانب التحول الاستراتيجي نحو آسيا الذي أُعلن عنه رسمياً عام 2011. وبهذا المعنى، جرى التعامل مع ليبيا باعتبارها أزمة يمكن احتواؤها، لا مشروعاً سياسياً يتطلب استثماراً طويل الأمد[12] .
ومع وصول دونالد ترامب إلى السلطة في ولايته الأولى في يناير 2017، لم يطرأ تحول جوهري على الاستراتيجية الأميركية حيال ليبيا. ومع التسليم باختلافها الواضح في خطابها السياسي مع سياسة أوباما، إلا أن سياسة ترامب تجاه ليبيا تميزت بقدر أكبر من البراغماتية المباشرة، وبميل أوضح للابتعاد عن أي تدخل فاعل ومباشر في الملف الليبي” لصالح الحلفاء الأوروبيين والإقليميين.
حيث تراجع الدور الأميركي أكثر خلال الأعوام( 2017–2020)، واقتصر في الغالب الانخراط غير المباشر وترك إدارة الملف الليبي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وللدول الأوروبية، ولا سيما إيطاليا وفرنسا، المعنيتين مباشرة بتداعيات الهجرة غير النظامية وعدم استقرارها الأمني.
ورغم بروز منافسين حقيقيين للولايات المتحدة في الساحة الليبية منذ عام 2018، وعلى رأسهم روسيا الاتحادية، التي وسعت حضورها غير المباشر عبر أدوات عسكرية وأمنية، فإن الولايات المتحدة لم تبادر إلى مواجهة هذا التمدد باستراتيجية شاملة، بل فضّلت إدارة التوازنات عبر وسائل غير مباشرة، من خلال “تحريك حلفائها”، أو استخدام أدوات الضغط الدبلوماسي، بما ينسجم مع تصورها لليبيا كدولة ثانوية لا تستدعي انخراطاً مباشراً واسع النطاق، ولعل هذا ما عبر عنه الرئيس ترامب صراحة بقوله بالنص: “إنه لا يرى دوراً للولايات المتحدة في ليبيا باستثناء هزيمة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية، معتبراً أن بلاده “لديها ما يكفي من الأدوار”[13].
إلا أن هذا التدخل العسكري الأميركي في ليبيا ـ شهد حالات أخرى لاحقاً في فبراير 2019، في ظل رئاسة دونالد ترامب، حيث نفذت الولايات المتحدة عمليات عسكرية نوعية محدودة في مناطق متفرقة من الجنوب الليبي، استهدفت قيادات وعناصر تابعة “لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، في مناطق صحراوية نائية قرب الحدود الجنوبية [14].
غير أن هذه التدخلات، على أهميتها العسكرية، لا يمكن فهمها باعتبارها تحولاً في الاستراتيجية الأميركية تجاه ليبيا، بل تمثل استثناءً أمنياً مرتبطاً بتهديد محدد. فقد ظل الهدف الأميركي محصوراً في إزالة خطر مباشر وفوري يهدد الأمن الإقليمي والأوروبي، لا في الانخراط في إعادة بناء الدولة الليبية أو إدارة الصراع الداخلي.
ومن ثم، عكست هذه العمليات منطق الضربة الوقائية المحدودة، التي تسعى إلى تحييد تهديد طارئ بأقل كلفة ممكنة، دون المساس بجوهر المقاربة الأميركية التقليدية التي ترى في ليبيا ملفاً ثانوياً يمكن التعامل معه عبر إدارة الأزمات، لا عبر استثمار استراتيجي طويل الأمد.
ويقدّم نمط التدخل العسكري الأميركي في ليبيا دليلاً إضافياً على محدودية موقعها في سلم الأولويات الاستراتيجية لواشنطن، إذ اقتصر هذا التدخل، بصورة شبه حصرية، على الضربات الجوية والعمليات الاستخباراتية عن بُعد، دون أي انتشار بري منظم للقوات الأميركية. فهذا النمط يختلف جوهرياً عن مقاربة الولايات المتحدة في ساحات أخرى واجهت فيها التهديد ذاته المتمثل في تنظيم «الدولة الإسلامية»، كما هو الحال في العراق وسوريا، حيث اختارت واشنطن الانخراط المباشر عبر نشر قوات خاصة، ومستشارين عسكريين، وإقامة قواعد ميدانية دائمة أو شبه دائمة، والإشراف المباشر على عمليات إعادة بناء القدرات الأمنية المحلية. غياب هذا النموذج “التدخل العسكري الأميركي المباشر ” في الحالة الليبية لا يمكن تفسيره فقط بخصوصية الجغرافيا أو تعقيد المشهد الداخلي، بل يعكس في جوهره قراراً استراتيجياً بتفادي التورط في ساحة لا تُعد مركزية للأمن القومي الأميركي. فالضربات الجوية في ليبيا جاءت بوصفها أداة احتواء مؤقتة لتهديد طارئ، لا كجزء من حملة شاملة لإعادة تشكيل البيئة الأمنية. ومن ثم، فإن الاكتفاء بالقوة الجوية، دون ترجمة ذلك إلى حضور ميداني أو التزام طويل الأمد، يعكس منطق إدارة الخطر بأقل كلفة، لا منطق الحسم الاستراتيجي، ويؤكد استمرار النظر إلى ليبيا باعتبارها مسرحاً هامشياً مقارنة بساحات اعتُبرت أكثر التصاقاً بالمصالح الأميركية المباشرة[15].
ومع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في يناير 2021، واصلت إدارته التعامل مع الملف الليبي من منظور إدارة الصراع لا حله، ومن خلال دعم مسار الأمم المتحدة، ولا سيما مخرجات مؤتمر برلين (2020–2021) والجهود اللاحقة لإجراء انتخابات مؤجلة، دون الاستثمار السياسي أو الأمني الكافي لفرض تسوية شاملة. الفارق الوحيد الذي يمكن رصده بين إدارة بايدن والإدارات الأميركية التي سبقته وخصوصاً الاثنين الآخرتين (أوباما/ ترامب)، هو ازدياد التركيز الأميركي على منع تحوّل ليبيا إلى ساحة نفوذ دائم للقوى المنافسة، خاصة روسيا، في ظل تصاعد التنافس الدولي بعد عام 2022.
غير أن هذا الهدف ظل محكوماً بذات القيد التقليدي وهو أن يتم تحقيقه بأقل التكاليف الممكنة، ومن دون انخراط مباشر. ولذلك، استمرت واشنطن في الاعتماد على أدوات غير مباشرة، مثل التنسيق مع الحلفاء الأوروبيين، ودعم بعض التوازنات الإقليمية، مع الحفاظ على حضور دبلوماسي محدود[16].
الفارق المشار إليه آنفا، يتجسد في إعلان إدارة بايدن في شهر أبريل 2022، أن الولايات المتحدة ستعطي الأولوية للمشاركة والشراكة مع ليبيا في إطار الاستراتيجية الأميركية لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار. هذه الاستراتيجية هي عبارة عن مبادرة طويلة الأجل لتعزيز عالم أكثر سلامًا واستقرارًا، ومدعومة باستثمارات أميركية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وتمثل التزامًا أميركيًا كبيرًا لدعم ليبيا وتقدمها نحو مستقبل أكثر سلاماً.
وترتكز هذه الخطة على رؤية تقوم على قيام دولة ليبية موحدة تحكمها سلطة منتخبة ديمقراطياً ومعترف بها دولياً، قادرة على حماية حقوق الإنسان، وتقديم الخدمات العامة، وتحقيق نمو اقتصادي شامل، وتأمين حدودها، والانخراط كشريك فاعل مع المجتمع الدولي، ويُفهم من هذا التحول أنه يعكس مراجعة أميركية لتجارب التدخل السابقة، وسعياً للانتقال من المقاربة الأمنية الضيقة إلى دعم مسارات الاستقرار المستدام، عبر أدوات دبلوماسية واقتصادية وتنموية، وتعزيز دور المؤسسات المدنية، وتقوية الشراكات متعددة الأطراف، بما يقلص احتمالات العودة إلى الصراع، ويرسخ حضور ليبيا ضمن أولويات الاستقرار الإقليمي. وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية، تشمل دعم الانتقال السياسي، ودمج الجنوب المهمش، وبناء مؤسسة عسكرية وأمنية موحدة خاضعة للسلطة المدنية، وتحسين البيئة الاقتصادية والحوكمة الرشيدة. وتعتمد الخطة على شراكات مجتمعية وبرامج قابلة للتوسّع لدعم الانتخابات والمصالحة الوطنية وتعزيز الاستقرار طويل الأمد[17].
غير أنّ القراءة المتأنية لمسار التفاعل الأميركي مع الملف الليبي منذ إعلان هذه الاستراتيجية تكشف عن فجوة واضحة بين الخطاب المعلن والممارسة الفعلية على الأرض. فطوال سنوات حكم بايدن لم تسجل شواهد سياسية أو اقتصادية أو أمنية ملموسة تشير إلى الشروع الجدي في تنفيذ هذه الخطة، لا من حيث حجم الاستثمارات الموعودة، ولا من حيث إطلاق برامج مؤسسية كبرى تعكس أولوية ليبيا ضمن الأجندة الأميركية. بل ظلّ التعاطي الأميركي محصورًا في دعم شكلي للمسار الأممي وإدارة الأزمة بدل الانتقال إلى معالجتها، مع استمرار غياب أدوات الضغط أو الحوافز الكفيلة بدفع الفاعلين الليبيين نحو تسوية شاملة[18].
وعلى الرغم من الطابع التراكمي والمؤسسي للسياسة الخارجية الأميركية، فإن خصوصية نمط أداء الإدارة اللاحقة لمرحلة بايدن، وما يتسم به من براغماتية عالية وإعادة ترتيب للأولويات العالمية، لا يسمح بالاعتقاد بأن هذه الاستراتيجية العشرية ستحظى بالاستمرارية أو ستُعتمد كإطار حاكم للسياسة الأميركية تجاه ليبيا، الأمر الذي يجعلها أقرب إلى إعلان نوايا سياسي منها إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ.
رابعًا- الملف الليبي وولاية ترامب الثانية (2025)
خلال الفترة التي انقضت من مدة الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب (عام 2025)، برزت مؤشرات إضافية تعزز الفكرة المركزية التي تحكم الاستراتيجية الأميركية تجاه ليبيا، والقائمة على اعتبارها دولة تقع في هامش الاهتمام الاستراتيجي، وليست ضمن دوائر الأولوية الحيوية للأمن القومي الأميركي. فقد اتسم التعاطي الأميركي مع الملف الليبي خلال هذه المرحلة بقدر واضح من الاستمرارية مع المقاربات السابقة، دون مبادرات نوعية أو تحولات كبرى تعكس إعادة تموضع حقيقي لليبيا داخل حسابات واشنطن. كما غاب أي انخراط سياسي أو اقتصادي مباشر واسع، واقتصر الحضور الأميركي على متابعة التطورات من زاوية إدارة المخاطر ومنع الانزلاق إلى فوضى أوسع، مع ترك مساحات أكبر للأطراف الإقليمية والدولية للتعامل مع تفاصيل المشهد الليبي، بما يعكس استمرار النظر إلى ليبيا بوصفها ملفًا ثانويًا مقارنة بقضايا دولية أكثر إلحاحًا[19].
فرغم التغيرات الدولية المتسارعة، وتصاعد حدة التنافس مع روسيا والصين، لم تشهد السياسة الأميركية تجاه ليبيا خلال هذه الفترة أي انتقال نوعي من منطق “إدارة الأزمة” إلى منطق “الانخراط الاستراتيجي”، بل استمرت المقاربة ذاتها التي تفضّل الحد الأدنى من التدخل، والاعتماد على أدوات غير مباشرة، وترك مساحات واسعة للحلفاء الإقليميين والدوليين.
فمع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، لم تشهد المقاربة الأميركية تجاه ليبيا تحولًا نوعيًا يخرجها من إطارها التاريخي التقليدي بوصفها ملفًا ثانويًا في سلم الأولويات الاستراتيجية الولايات المتحدة. ومع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، واستمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا، إلا أن إدارة ترامب حافظت في ولايتها الثانية على نهج يقوم على إدارة الأزمة لا حلها، وعلى تفويض الأدوار بدل الانخراط المباشر، وعلى تغليب الاعتبارات الاقتصادية البراغماتية على الاستثمار السياسي والأمني طويل الأمد.
في هذا السياق، برز الدور المركزي للسفير الأميركي لدى ليبيا بوصفه الأداة الأساسية لإدارة الملف الليبي، إلى جانب المبعوث الأميركي الخاص، حيث تولّت هذه القنوات الدبلوماسية مهمة التواصل مع الأطراف الليبية، لكن ضمن حدود واضحة لا تتجاوز التنسيق، وتقديم النصح، وحماية المصالح الاقتصادية الأميركية. ولم تُسند إلى هذه القنوات صلاحيات ضغط حقيقية أو تفويض سياسي واسع يسمح بفرض تسويات أو ممارسة إكراه دبلوماسي فعّال على الفاعلين الليبيين، سواء من النخب السياسية أو القيادات العسكرية في الشرق والغرب[20].
وقد عكس هذا الترتيب المؤسسي إدراك إدارة ترامب بأن أي انخراط أميركي مباشر في إعادة هندسة المشهد السياسي الليبي سيحمل كلفة سياسية وأمنية لا تتناسب مع القيمة الاستراتيجية المتوقعة من ليبيا. لذلك، جرى الإبقاء على الدور الأميركي في مستوى «الوسيط الاقتصادي والداعم الدبلوماسي»، مع ترك إدارة الملف وتفاصيله “كما هو معتاد” للأمم المتحدة، والدول الأوروبية، والحلفاء الإقليميين.
التطور الوحيد الذي يمكن ملاحظته في الاستراتيجية الأميركية حيال ليبيا هو أن إدارة ترامب في ولايتها الثانية أعادت التأكيد ـ كما هو الشأن في جل إن لم يكن كل علاقاتها الدولية ـ على أولوية البعد الاقتصادي في التعامل مع ليبيا، ولا سيما ملف الطاقة والمؤسسات السيادية المرتبطة به.
فقد انصبّ الاهتمام الأميركي على ضمان استمرارية إنتاج النفط، ومنع انهيار المؤسسة الوطنية للنفط، والحفاظ على قنوات التواصل مع مصرف ليبيا المركزي، باعتبار هذه المؤسسات تمثل الضامن الأساسي لاستقرار الحد الأدنى للدولة الليبية، ولعدم تحوّل الأزمة إلى مصدر اضطراب واسع في أسواق الطاقة أو في محيط البحر المتوسط [21] .
وعليه، كثّف السفير الأميركي والمبعوث الخاص لقاءاتهم مع مسؤولي وزارة النفط والغاز، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمصرف المركزي، سواء داخل ليبيا أو عبر لقاءات خارجية، وتركزت هذه اللقاءات على قضايا الشفافية، وتوحيد الإجراءات المالية، وتهيئة بيئة قانونية أكثر استقرارًا تسمح بعودة أو توسع نشاط الشركات الأجنبية، بما في ذلك الشركات الأميركية، دون أن يرتبط ذلك بمشروع سياسي متكامل لإعادة بناء الدولة. هذا التركيز الاقتصادي يعكس بوضوح منطق إدارة ترامب القائم على التعامل مع ليبيا باعتبارها “سوقًا محتملة ومصدر طاقة”، لا باعتبارها ساحة مركزية للصراع الجيوسياسي تتطلب حضوراً عسكرياً أو سياسياً مباشراً. فالإدارة الأميركية، في هذه المرحلة، لم تُبدِ استعداداً لنشر قوات، أو إنشاء قواعد، أو رعاية ترتيبات أمنية جديدة، بل اكتفت بالتنسيق المباشر وغير المباشر مع الحلفاء الإقليمين والدوليين.
في المجمل وفي الوقت الذي يُلاحظ فيه غياب أي جهد أميركي جاد للضغط المنهجي على القوى الليبية الرئيسية، سواء السياسية أو العسكرية، لدفعها نحو تسوية ملزمة، ذلك يعكس مقاربة واعية من جانب واشنطن، ترى في استمرار الجمود والانقسام تكلفة مقبولة لإدارة ملف لا يحتل مرتبة متقدمة ضمن أولويات الإدارة الأميركية. فلم تُستخدم أدوات العقوبات بشكل واسع، ولم تُربط المساعدات أو القنوات الاقتصادية بشروط سياسية واضحة، ما أسهم في تكريس حالة من الجمود واللامبالاة المتسارعة إزاء تطورات النزاع الليبي، وتعميق الاعتماد على الوسطاء الدوليين للحفاظ على استقرار مؤقت، وهو ما يُظهر أن هذا التعاطي لم يُنظر إليه كإخفاق، بل كخيار عملي لإدارة ملف حساس دون انغماس كامل في صراعات داخلية معقدة[22].
إن مقارنة هذا المستوى من الاهتمام بالملف الليبي مع تعامل إدارة ترامب في ولايتها الثانية مع ملفات أخرى، مثل الصين، أو أوكرانيا، أو في ملفات مشابهه كالملف السوري والملف العراقي، يكشف بوضوح الفارق في حجم الانخراط والموارد والاهتمام السياسي، فبينما تُدار تلك الملفات من أعلى مستويات صنع القرار، وتُخصّص لها أدوات ضغط متعددة، يظل الملف الليبي محصوراً في نطاق السفارة والمبعوث الخاص، دون انتقاله إلى مستوى القرار الاستراتيجي الأعلى.
الخاتمة:
انطلاقاً من الفرضية المركزية التي تقوم عليها هذه الورقة فإن استقراء السلوك الأميركي حيال ليبيا منذ نشأتها في مطلع خمسينيات القرن الماضي يظهر الكثير من الدلائل والشواهد التي تثبت أن الولايات المتحدة لم تنظر إلى ليبيا، في أي مرحلة تاريخية سابقة وصولًا إلى المرحلة الحالية التي يترأسها دونالد ترامب (خلال عام 2025)، باعتبارها ساحة مركزية للأمن القومي الأميركي، بل بوصفها ملفاً يمكن احتواؤه وضبط تداعياته دون انخراط مباشر واسع، وحتى في لحظات التدخل العسكري كما في عام 2011 أو في ضربات مكافحة الإرهاب اللاحقة، كان السلوك الأميركي محكوماً بمنطق الاستثناء والضرورة الظرفية، لا بمنطق الالتزام طويل الأمد.
وقد عزز هذا النهج إدراك واشنطن لمحدودية العائد الاستراتيجي من أي استثمار سياسي أو أمني كبير في ليبيا، مقارنة بملفات أخرى أكثر أولوية وتأثيرًا في موازين القوى الدولية. وفي هذا الإطار، تبرز الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب بوصفها امتدادًا مكثفًا وواضحًا لهذا المنطق التاريخي، لا خروجًا عنه. إذ لم تشهد الاستراتيجية الأميركية تجاه ليبيا (خلال عام 2025) أي انتقال من مستوى “الهامش” إلى مستوى “الانخراط المباشر”، بل على العكس، تعمّق الاعتماد على أدوات غير مباشرة، وعلى تفويض الأدوار للأمم المتحدة والحلفاء الإقليميين والدوليين. وقد اقتصر الحضور الأميركي الفعلي على القنوات الدبلوماسية، ممثلة في السفارة والمبعوث الخاص، مع تركيز وظيفي واضح على حماية المصالح الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها استقرار إنتاج النفط، واستمرار عمل المؤسسات السيادية، ومنع انهيار كامل قد ينعكس سلبًا على أسواق الطاقة أو الأمن الأوروبي.
إن هذا التركيز على البعد الاقتصادي، بمعزل عن مشروع سياسي متكامل لإعادة بناء الدولة، لا يعكس فقط براغماتية إدارة ترامب، بل يعبّر عن جوهر “نموذج إدارة الهامش الاستراتيجي” الذي تتبناه الولايات المتحدة في تعاملها مع ليبيا. فواشنطن لا ترى في ليبيا ساحة صراع تستوجب الحسم، بل مساحة رخوة يمكن ضبطها عند حدّها الأدنى، وتركها تتفاعل داخليًا وإقليميًا طالما لم تُهدد المصالح الأميركية المباشرة. ومن ثم، فإن غياب الضغوط الجدية لفرض تسوية سياسية، أو استخدام أدوات الإكراه الدبلوماسي والاقتصادي بشكل ممنهج، ليس عجزًا بقدر ما هو خيار محسوب.
وعليه، تؤكد هذه الورقة أن السياسة الأميركية تجاه ليبيا، بما في ذلك في الولاية الثانية للرئيس ترامب، هي تعبير عن رؤية استراتيجية متماسكة ترى في ليبيا دولة هامشية، تُدار أزمتها ولا تُحل، ويُضبط مسارها دون إعادة صياغته.
إن هذا الإدراك ضروري لفهم حدود الدور الأميركي، وتفسير أسباب استمرار جمود الملف الليبي، كما أن هذا الادراك يشكّل مدخلًا واقعيًا لأي مقاربة ليبية أو إقليمية تسعى للتعامل مع الولايات المتحدة، بعيدًا عن القراءات السياسية القائلة بإمكانية تدخل حاسم أو رعاية أميركية شاملة لملف الأزمة الليبية.
[1] – ما هو القادم للقوى العالمية في ليبيا التي مزقتها الحرب؟، موقع الجزيرة نت
أنظر أيضاً، زيد محمد خضير، “أهداف السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط بين 2011 و2021 “، مجلة مراجعات السياسة الخارجية، الأكاديمية المجرية للعلوم، حاول الباحث توضح أولويات السياسة الأميركية في الشرق الأوسط وذكر فيه أن بعض الملفات مثل ليبيا لا تُعد من الأولويات الاستراتيجية الكبرى مقارنةً بالخليج وإسرائيل، ضمن سياق أهداف المنطقة الأوسع:
Khidhir, Z. M. (2021). US Foreign Policy Goals in the Middle East Between 2011 and 2021, Foreign Policy Review, 14(3), pp. 164–182.
[2]– Karim Mezran and Arturo Varvelli (eds.), Foreign Actors in Libya’s Crisis (Milano: Ledizioni LediPublishing, 2017), pp. 1–138.
[3] -للوقوف على بعض من سياق التسلسل التاريخي أنظر: السيد عوض عثمان، مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر، 1994.
[4] -سمية أمين ياسين، سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه ليبيا 1958ـ 1960 في ضوء وثائق الخارجية الأميركية، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، العدد 3، مارس 2010، المجلد 17، ص ص 327 -344.
[5] -مصطفى أحمد بن حليم، صفحات مطوية من تاريخ ليبيا، 1992، ص ص 67 -108.
[6] -يتناول هذا السياق مرحلة التوتر الحاد في العلاقات الليبية-الأميركية خلال ثمانينيات القرن العشرين، خاصة في عهد الرئيس رونالد ريغان، حيث شملت المواجهات حادثة خليج سرت، والغارات الجوية عام 1986، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية وتصنيف ليبيا دولة راعية للإرهاب. للمزيد من المعلومات أنظر: سيد عبد الرحيم أبوخبر، دار زهير للنشر، القاهرة، 2016، سياسة الولايات المتحدة حيال ليبيا 1969 ،1989، ص ص 262 -264.
[7] الدول المارقة هو مصطلح لا يحمل تعريفًا أو اعترافًا قانونياً دولياً من قِبل المنظمات العالمية أو الأمم المتحدة، بل هو وصف سياسي يُستخدم حصرياً في إطار السياسة الأميركية. هو تعبير أطلقته الإدارات الأميركية المتعاقبة لوصف دول ترى أنها خارجة عن السياق الدولي، وهو سياق يعتمد بشكل رئيسي على وجهة النظر الأميركية التي قد لا تتوافق بالضرورة مع وجهات نظر الدول الأخرى”. ورغم أن مصطلح “الدول المارقة” لا يُعد تصنيفاً رسمياً في النظام الأميركي، إلا أن الولايات المتحدة قامت بالفعل بفرض “قيوداً مشددة، وعلى مدى عقود على عدد من الدول من بينها ليبيا شملت حظر المساعدات الخارجية، وتجميد صادرات ومبيعات الأسلحة، بالإضافة إلى ضوابط على المواد ذات الاستخدام المزدوج وقيود مالية متنوعة”. للمزيد أنظر: نعوم تشومسكي، الدولة المارقة – استخدام القوة في الشؤون العالمية، ترجمة: أسامة إسبر، منشورات مطبعة العبيكان، 2004، الطبعة الأولى، ص ص 33 ـ 79.
[8]– بعد التسعينيات، أقدمت ليبيا على تخفيف حدة التوتر مع الغرب عبر التسليم الجزئي للمتهمين في قضية لوكربي وإجراء تسوية قضائية، ثم دفع تعويضات لأسر الضحايا، مما ساعد على بدء مسار نحو التعاون وتقارب محدود مع الولايات المتحدة وأوروبا بعد سنوات من العزلة والعقوبات للمزيد أنظر في: موقع الجزيرة، العلاقات الأميركية الليبية: 1969- 2003، urlr.me/K7YmhZ، تاريخ الدخول (15/12/2025).
كذلك: Policy shift and rapprochement described in Libya’s Reconciliation with the West: Implications for U.S. (pp. 8–9).
[9] -للمزيد حول قضية لوكربي أنظر: رجب ضو لمريض، جامعة الدول العربية وقضية لوكربي، منشورات الدار الأكاديمية للنشر والتأليف والترجمة، طرابلس، 2006، الطبعة الأولى، ص ص 41، 51.
[10] -منى حسين عبيد، العلاقات الليبية -الأمريكية، مجلة الأستاذ، جامعة بغداد، العدد 217، المجلد الثاني، السنة 2016، ص ص 433 ،450.
[11] -كريستوفر س شيفس، وجيفري مارتيني، ليبيا بعد القذافي عبر وتداعيات المستقبل، منشورات مؤسسة راند، بوسطن، 2014، ص ص 21-24.
[12] -للوقوف على أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول السياسة الخارجية الأميركية حيال ليبيا في عهد الرئيس باراك أوباما يمكن الرجوع إلى المراجع التالية: لوكا تاردلي (تقرير)، تدخلات بارك أوباما: أفغانستان ـ العراق ـ ليبيا، منشورات كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، 2012، ص ص 21-23. وكذلك: بول ويليامز، سياسة الرئيس أوباما تجاه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الشمال الاستراتيجي، مجلة جامعة كيس ويسترن ريزيرف للقانون الدولي، العدد 1، المجلد 48، 2016، ص ص 84 -101.
لكن بالرغم من ذلك يلاحظ أن الرئيس أوباما أدلى بتصريحات تبدو مناقضة بوضوح لهذه الاستراتيجية الأميركية حيال ليبيا عندما نشرت له تصريحات تلفزيونية قال فيها بالنص: “إن أكبر خطأ في رئاسته كان نقص التخطيط لما بعد الإطاحة بمعمر القذافي في ليبيا، مما ترك البلاد تغرق في دوامة من الفوضى يحكمها ميليشيات متنافسة تتنازع على السلطة”. أنظر في: urlr.me/57w8GF تاريخ الدخول (01/11/2025)
[13] –الجزيرة نت، ترمب: لا دور لأميركا بليبيا إلا هزيمة تنظيم الدولة،أنظر في: urlr.me/QXf5Tm تاريخ الدخول: (14/11/2025)
[14] –الجزيرة نت، أيمن محمد، في أوباري الليبية.. ضربات جوية تبحث عن تنظيم القاعدة، أنظر في : urlr.me/vJayxE تاريخ الدخول: (07/11/2025)
[15] -صفوت الزيات، العمليات العسكرية في ليبيا: القدرات والاحتمالات، مركز الجزيرة للدراسات، أنظر في: urlr.me/yqxUt6 تاريخ الدخول : (10/12/2025).
[16] -توماس فولك، سياسة بايدن تجاه ليبيا، البرنامج الإقليمي للحوار السياسي جنوب البحر الأبيض المتوسط، مؤسسة كونراد أديناور، أبريل 2021، ص ص 1-5.
[17] –موقع سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار الخطة الإستراتيجية العشرية لليبيا.
[18] -محمود عبد الهادي، إستراتيجية أميركا لمنع الصراع ودعم الاستقرار (8) | لماذا ليبيا؟، موقع الجزيرة نت، أنظر في: urlr.me/yn9b5A تاريخ الدخول : ( 10/12/2025)
[19] -للوقوف على أكبر قدر ممكن من الفهم لأسباب استمرار الولايات المتحدة في تجنب الاستثمار الفعلي في استقرار ليبيا والاعتماد على مقاربات محدودة (مثل مكافحة الإرهاب وتعاون دولي بدل التزام مباشر)، بدل أن تكون ليبيا أولوية استراتيجية في الأمن القومي الأميركي أنظر: بين فيشمان، بعد عام 2011، وقفت الولايات المتحدة على الحياد — والضرر يطال ليبيا»، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (Washington Institute)، يوليو 2024، أنظر في: urlr.me/ue7MnT تاريخ الدخول: (05/12/2025)
[20] -أحمد خليفة، تفاصيل التحركات الأميركية سياسيا وأمنيا بين الأطراف الليبية، موقع الجزيرة نت، أنظر في: https://www.aljazeera.net/. تاريخ الدخول: (9/11/2025).
[21] -تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعادة إدارة الملف الليبي عبر مسار تفاوضي مباشر يجمع ممثلين عن الشرق والغرب، متجاوزة دور بعثة الأمم المتحدة. ويرتكز هذا التوجه على منع انهيار المؤسسات المالية وضبط تدفقات النفط، باعتبارهما جوهر الصراع الداخلي. وتعكس التحركات الأميركية اعتمادًا متزايدًا على النفوذ الاقتصادي، من خلال الإشراف على المصرف المركزي وتقييد أدوات التمويل غير المنسقة، بما يحدّ من نفوذ المنافسين الدوليين. ويهدف هذا النهج إلى إعادة هندسة التوازنات الداخلية وفرض استقرار وظيفي مؤقت، لكنه في المقابل يعزز الاعتماد الليبي على الوساطة الأميركية، ويؤجل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة يقودها الليبيون أنفسهم. في ذلك أنظر: موقع الجزيرة، ليبيا تعرض شراكة اقتصادية بـ 70 مليار دولار مع أميركا،للمزيد أنظر في: urlr.me/u2rctB، تاريخ الدخول: (04/11/2025).
[22] -بين فيشمان، إعادة تحديد إطار ليبيا لصالح إدارة أمريكية متردّدة، فبراير 2021، أنظر في: urlr.me/NJUutb ، تاريخ الدخول: (10/10/2025)
يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF




